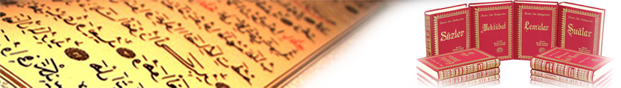بعد فراقٍ طويل
لعلها سبعٌ وعشرون أو ثمانٌ وعشرون سنةً مضت لم أحْظَ فيها بلقاء الأستاذ.. ولطالما وددت أن أزوره وأمتِّع ناظري برؤية مُحيّاه المبارك، لكنَّ تزاحُم المشاغل لم يسنح لي بفرصةٍ من هذا القبيل، إلا أنه برغم هذا ظلَّ يسكن في القلوب، فكان حاضرًا معنا على الدوام بوجوده المعنوي؛ لكن أيكفي هذا ليطفئ لواعجَ الأشواق؟! كلا؛ فلقد أبانت فرحتُنا بلقائه ومعانقته ورؤية طلعته البهية عن عظيم شوقنا إلى لقياه ومجالسته.
لقد مضى على تعرُّفنا إلى الأستاذ أربعون سنة، كان في تلك الأيام كثيرًا ما يتردد إلى غرفة الإدارة(في «دار الحكمة الإسلامية» باسطنبول) فنقضي بمجالسته أمتع الأوقات، ونتجاذب معه أطراف حديثٍ عذبٍ يمتد لساعاتٍ بصحبة السادة الأفاضل محمد عاكف ونعيم وفريد وإسماعيل حقي الإزميري؛ وكان يتحدث في المسائل العلمية الدقيقة بلهجته الآسرة، فكانت القوة والعزة التي تطبع حديثه تثير مشاعرنا، وكان ذكاؤه الفطري الخارق وموهبته الإلهية يتجليان في تناوله لأعضل المسائل.
إنه صاحب ذهنٍ وقَّاد لا ينشغل كثيرًا بالنُّقول، وإنما مرشدُه القرآنُ وحده، فهو منبع ذكائه وفيوضاته، ومنه نبعت جميعُ لمعاته؛ وهو كذلك صاحبُ رأيٍ يبلغ به درجة إمامٍ مجتهد، إنه رجلٌ يحمل بين جنبيه قلبًا مُترعًا بالإيمان كصحابيٍّ، وتَعمُرُ روحَه شهامةُ عمر، يعيش في القرن العشرين بروحِ مؤمنٍ في عصر الرسالة، ليس له هدفٌ سوى الإيمان والقرآن.
إن أعظم عمدةٍ له ولرسائل النور إنما هي الإيمانُ بالله وتوحيدُه اللذان هما لُباب غاية الإسلام، وإنه لَيُكِنُّ من العداوة للشرك وعبادة الأوثان ما لو قُدِّر له أن يعيش في فجر الإسلام لأُوكلت إليه مُهمة تحطيم الأصنام في ذلك الحين.
لقد عاش ما يناهز قرنًا من الزمان يجاهد في ترسيخ حقائق الإيمان والقرآن في القلوب، وكانت حياته فوق ذلك حياةَ فضيلةٍ وشهامة، عرفتْه ساحات الوغى باسلًا مقدامًا يَكُرُّ على عدوه ماضيَ العزيمة ثابتَ الجَنان، وعرَفَه الأسرُ بطلًا لا يَعبأ بآسريه ولا تُرهبه مِنَصَّة الإعدام، حتى لقد جعل قائدَ الأعداء يراجع قراره ويثوب إلى الإنصاف.
إنه فدائي لا يتردد في التضحية بروحه في سبيل الأمة والوطن، وهو خصمٌ عنيدٌ للفتنة والإفساد والتخريب، يتحمل صنوف الظلم والأذى في سبيل مصلحة الأمة، ويترفَّع حتى عن الدعاء على مَن ظلمَه، بل يرجو الصلاح والإيمان لمن زجوا به في السجون، ويهون عنده الموت في سبيل غايته القدسية.
أما طعامه فقدَحُ حَساء وكأسُ ماء ولقيماتُ خبز، وأما لباسه فغايةٌ في البساطة والتزهد: كساءٌ قطنيٌّ أبيض، وهو مع هذا بالغُ الاهتمام بالنظافة، يبدل ثيابه ويغسلها قبل أن تتسخ.. لا يحمل العملة الورقية ولا يَمَسُّها بيده.. لا يملك من متاع الدنيا شيئًا.. يعيش لأمته لا لنفسه.
نحيف القامة غير طويل، لكنه جليلٌ مَهيب، ثاقب النظرات تُشِعُّ عيناه ببريقٍ عجيب.. قد يكون أفقر مَن في الدنيا مادةً.. لكنه سلطانٌ في عالَم المعنويات.
لم تفلح آلام سنوات عمره التي تربو على الثمانين في أن تخط التجاعيد في وجهه.. إنما وحده شعره هو الذي غزاه الشيب.. أزهر اللون.. حليق اللحية.. مفعمٌ بالنشاط كأنه شاب.. هادئٌ لطيف المعشر.. لكنه متى احتدمت الأمور اعتدل في جلسته كأنه أسد وتحدث بكلامٍ هادرٍ كأنه سلطانٌ على عرشه.
لا شيء أبغض إليه من السياسة.. قد منعها على نفسه ومنع طلابَه من الانشغال بها.. وقد مضى عليه إلى اليوم خمسٌ وثلاثون سنةً لم يقرأ فيها صحيفة.. قطع علاقته بشؤون الدنيا وانشغل بالعبادة فلا يستقبل أحدًا من بعد صلاة المغرب إلى ظهر اليوم التالي.. يُحيي ليلَه ولا يهجع إلا قليلًا.
ينتشر طلابه في شتى أنحاء البلاد، ويربو عددهم على ستمئة ألف، بل لعلهم يبلغون المليون.. هم خيرة أبناء البلد.. وفيهم مئاتٌ بل آلافٌ يُحصِّلون العلوم الحديثة في مختلف الجامعات والكليات، لا تجدهم إلا صفوةَ أقرانهم خُلُقًا وفضيلةً وجِدًّا واجتهادًا.. ومع انتشار طلاب رسائل النور بمئات الآلاف في شتى أنحاء البلد، إلا أنك لا تجد لأحدٍ منهم واقعةَ إخلالٍ بالأمن أو خروجٍ على النظام.. بل كلُّ واحدٍ منهم بمثابة رقيبٍ معنويٍّ يرعى أمنَ البلاد واستقرارَها، ويحافظ عفويًّا على نظامها وانتظامها.
سألته إن كان لقي مشاقَّ في سفره إلى اسطنبول، فأجابني:
ما يشق عليَّ هو المخاطر التي يتعرض لها العالم الإسلامي.. فقديمًا كانت المخاطر تأتيه من الخارج، وكانت مقاومتُها أسهل.. أما اليوم فتأتيه من الداخل.. وقد وصل النَّخر إلى الجذع وباتت مقاومته أصعب.. وأخشى ألا تقدر عليه مجتمعاتنا.. فإنها لا تشعر به، بل تنظر إلى أعدى أعدائها الذي يقطع شرايينها ويمتص دمها على أنه وليُّها الحميم.. وإذا عَمِيَتْ بصيرة المجتمعات على هذا النحو فإن مَعقِلَ الإيمان في خطر.. فهذا هو ما يشقُّ عليَّ لا سواه، وإلا فلا وقت لدي للتفكير فيما أتعرض له من مشاق ومعاناةٍ شخصية.. ألا ليت هذه المشاق كانت عشرة أضعافٍ وسلِمَ في المقابل مَعقِلُ الإيمان ومستقبلُه.
ألا تمنحكم الآلاف المؤلَّفة من طلابكم المؤمنين السُّلوان والأملَ في المستقبل؟
بلى.. لستُ متشائمًا تمامًا.
…….
يمر العالَم اليوم بأزمةٍ معنويةٍ كبرى، وتنتشر فيه يومًا بعد يومٍ الآفاتُ والأمراضُ التي ظهرت في المجتمع الغربي ذي الأُسس المعنوية المتصدعة، فبأيَّة حلولٍ سيتصدى العالَم الإسلامي لهذه الأمراض الفتَّاكة؟ هل سيواجهها بِنفس الحلول الباطلة التي صاغها الغرب الذي يعاني التفكك والانحلال؟ أم سيواجهها بأُسسه الإيمانية المتينة النقية؟
إنني أرى أصحاب العقول الكبيرة في غفلة، ولا يمكن لأسس الكفر النَّخِرة أن تُتخذ دعائم لقلعة الإيمان، ولهذا أجدني أُكثِّف جهودي لقضية الإيمان لا غير.
إنهم لا يفهمون رسائل النور أو لا يريدون فهمها.. يظنونني شيخًا تقليديًّا غارقًا في جدليّات المذاهب وصفحات المتون والشروح.. لقد اشتغلتُ بالعلوم الحديثة وما أنتجه العصر من معارف وفلسفات، حتى حَلَلتُ أعمق المسائل بهذا الخصوص، وألَّفت فيها مؤلفاتٍ، لكني لا أعرف حذلقة الكلام والتلاعب بالألفاظ، ولا أُعير التفاتًا لمُخاتَلات الفلسفة.. وإنما همِّي هذه الأمة: حياتُها الجَوَّانية ووجودُها المعنوي وضميرُها وإيمانُها.. وليس لي شغلٌ إلا بأساسَي التوحيد والإيمان اللذَين أرساهما القرآن.. فهما الدِّعامة التي تقوم عليها أمة الإسلام.. ومتى تزعزعت هذه الدِّعامة كان وجود الأمة في خطرٍ ماحق.
يقولون لي: لماذا تعرَّضتَ لهذا وذاك؟
أقول: لم أنتبه لذلك.. فأمامي حريقٌ هائل يبلغ لهيبه عَنان السماء.. يحترق فيه أبنائي.. وتصل ألسنة ناره إليَّ.. فأهبُّ مسرعًا لأُخمِد الحريق وأُنقِذَهم.. فيقف أحدهم في طريقي يريد إعاقتي، فتَصدِمه قدمي.. ما أهمية ذلك؟ ما قيمةُ حادثةٍ تافهةٍ كهذه إزاء هذا الحريق الهائل؟ تفكيرٌ ضيقٌ ونظرٌ قاصر.
أيظنونني رجلًا أنانيًّا لا همَّ له إلا خَلاصُ نفسه؟! لقد ضحَّيتُ بكلِّ ما لدي في سبيل إنقاذ إيمان المجتمع، بل ضحَّيت حتى بآخرتي.. إنني على مدى حياتي الممتدة نيِّفًا وثمانين سنة لم أعرف شيئًا من لذائذ الدنيا ومباهجها، فقد انقضى عمري إما في ساحات القتال أو في معسكرات الأسر أو في سجون بلدي أو في محاكمها، ولم تبق شِدَّةٌ إلا عانيتُها ولا أذًى إلا ذقتُه.. عومِلتُ في المحكمة العسكرية كمجرمٍ، ونُقِلتُ من منفًى إلى منفًى كإرهابيٍّ مخرِّب، ومُنِعتُ في سجون بلدي من التواصل مع الآخرين شهورًا طويلة، وسُمِّمتُ مراتٍ عديدة، ولقيتُ صنوفًا من الطعن والحط والإزراء، حتى لقد فضلت في بعض الأحيان الموت على الحياة، ولولا أن ديني يمنعني من الانتحار لكان سعيدٌ مُغيَّبًا تحت الثرى منذ زمنٍ بعيد.
إن لي فطرةً لا تقبل الذل والمهانة، وإن عزة الإسلام وشهامته تمنعانني منهما أشدَّ المنع، فليكن خصمي مَن كان، فلستُ أذِلُّ له ولو كان أعتى ظالمٍ جبار، أو ألدَّ عدوٍ سفاكٍ للدماء، بل أردُّ عليه ظُلمَه وبطشَه وإنْ كلَّفني ذلك الزجَّ في غياهب السجون، أو السَّوقَ إلى مِنَصَّات الإعدام، فلستُ أبالي بشيءٍ من ذلك إن وقع، بل قد وقع فعلًا وعاينتُه، ولو أن ذلك القائد الدموي في معسكر الاعتقال طاوعه قلبُه وضميرُه في الإمعان في الظلم قليلًا، لكان سعيدٌ اليوم ممن قضوا شنقًا والتحق بركب المظلومين.
هكذا مضت حياتي بين مشاق ومصائب ومِحَنٍ ومصاعب، وضحَّيتُ بنفسي ودنياي في سبيل إيمان المجتمع وسلامته وسعادته، فليهنأ بها؛ أنا لا أدعو على مَن ظلمني، لأنه بفضل هذه المشاق والمِحَن أصبحت رسائل النور وسيلةً لإنقاذ إيمان مئات الألوف إن لم يكن الملايين.. أنا لا أعرف عددهم بالضبط، هكذا يقولون، المدعي العام بـ«أفيون» قال: إنهم خمسمئة ألف.. فلله الحمد كثيرًا أنَّ بقائي على قيد الحياة وتحمُّلي المشاقَّ والمِحَن قد أسدى خدمةً لكلِّ هؤلاء بإنقاذ إيمانهم، فيما لو متُّ لما أنقذتُ سوى إيماني.
ولقد ضحَّيت بآخرتي كذلك في سبيل إيمان هذا المجتمع وسلامته، لا طمعًا في الجنة ولا خوفًا من النار، فإذا سَلِمَ إيمانُ المجتمع التركي ذي الخمسة والعشرين مليون نسمة.. بل إيمان المجتمعات الإسلامية التي تَعُدُّ مئات الملايين فَلْيَفْدِها لا سعيدٌ واحد، بل ألف سعيدٍ وسعيد.
إنه إن لم يكن على وجه الأرض جماعةٌ ترفع رايةَ القرآن فلستُ أرغبُ في الجنة.. بل ستكون هي نفسها سجنًا لي، وإنني راضٍ أن أحترق بنار جهنم في سبيل أن يَسلَمَ إيمانُ أبناء هذا الوطن، لأنه عندما يحترق جسدي سيكون فؤادي روضة أزهار.
كان الأستاذ في حالةٍ من الحماس والاندفاع، كان كبركانٍ يقذف بالحمم، أو كعاصفةٍ تهب على بحار القلوب فتتلاطم أمواجها، أو كشلالٍ دفاقٍ مهيبٍ يصب في أعماق الروح؛ استمر يتحدث كخطيبٍ هادرٍ في حشدٍ من الناس لا يريد أن يقطع عليه أحدٌ حديثَه.
شعرت بأنه قد تعب فأردتُ أن أغير الموضوع؛ سألتُه:
هل مللتم من المحاكمات؟
…….
أسألُ أساتذةَ الحقوق وأهلَ العلم: أيوجد في القانون مادةٌ تجرِّم مَن يؤيِّد تعليمَ الدين أو يؤيد الحفاظ على عفةِ وشرفِ نسائنا وبناتِ وطننا بتربيتهن التربيةَ الإسلامية؟ أم هل يوجد في قولي: «وَرَدتْ إلى القلب حقيقةٌ..» ونحوِه من التعابير ما يدل على أني أقصد بها تحقيق نفوذٍ شخصي؟
كان لقاؤنا بالأستاذ قد طال كثيرًا، ومضى الوقت سريعًا، فاستأذنَّا بالانصراف وغادرنا.
أشرف أديب
1952
كتاب سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذته
2852 مرة رسائل النور
رسائل النور